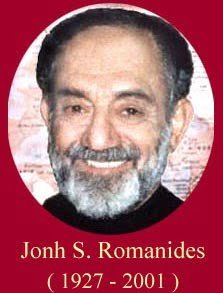الفداء
عن الأب الدكتور جورج عطية،
أستاذ سابق للعقائد في جامعة البلمند
الموقف الكاثوليكي من الفداء:
من كتاب مختصر في علم اللاهوت العقائدي (ترجمة مارديني) الذي يعتبرُ تلخيصاً لللاهوت الكاثوليكي يقول عن سر الفداء:(الفداء تحقق بواسطة رسالة المسيح الرعوية والتعليمية، ولا سيما بواسطة تعويضه النيابي واستحقاقات موته على الصليب، بهذا التعويض الذي جرى تقديمه على الصورة المذكورة تم التكفير عن الإهانات التي لحقت الله بالخطيئة، وأعيدت إلى شرف الله المهان كرامته. وبواسطة استحقاقات المسيح جمعت خيرات الخلاص لتوزع على المقتدين).
يقصد أن مجيء المسيح على الأرض بشخصه وتعليمه أفاد البشر، والمسيح عوّض عن البشر وكان نائباً عنهم ومثّلهم بموته على الصليب وبذبيحته وبطاعته، وبهذا التعويض أعيد إلى شرف الله كرامته، وأعطانا المسيح استحقاقات عمله الفدائي.
(مثل استحقاقات القديسين التي تفيضّ عما طلب منهم بحسب المفهوم الغربي، أي أن المسيح عندما قام بهذا العمل وبما أنه بارّ جمع هذه الاستحقاقات وأعطاها لنا).
وبذلك فإن كل ما فعله المسيح جيّره لنا.
وفي تاريخ العقائد نجد أنه حتى في القرون الأولى عند الآباء الغربيين مثل ترتليانوس، عندهم شئ من الموقف اللاهوتي الحقوقي في قضية الفداء، وذلك لأن الرومان كانوا أعظم أمة من حيث التشريع القانوني، فذهنهم كان حقوقيّاً أي أن كل شئ يتمُّ بالمقايضة والمبادلة حسب القانون التجاري، ومدروس حسب التشريع والعدل إنما الذي جعل هذا الموضوع كمبدأ متكامل هو (أنسلم دي كانتربيري) الذي هو أبو اللاهوت السكولاستيكي، لذلك تبنى السكولاستيكيون من بعده نظرته لسرّ الفداء. وذلك لمكانته البارزة لديهم فلم يعارضه أحدٌ. ونجدُ صدى هذه الفكرة يتردد في تعليم المجمع التريدنتي حتى أنَّ المجمع الفاتيكاني الأول فكر أن يرفع صريحاً فكرة الفداء كفدية وتعويض إلى مستوى عقيدة. هذا المبدأ ينسجم مع التعليم الغربي ككلٍ حيث يوجد تعليم واضح من المجمع التريدنتي أنَّ الإنسان أخطأ لهذا يجب أن يعاقب هو وكل ذريته. لهذا يعتبر كل إنسان حاملاً للخطيئة الجديّة مغضوب عليه بنظر الله ويستحق العقاب. بهذا الموقف لا يكون (أنسلم مخطئاً في محاولته البحث عن كيفية تنجية الإنسان من العقاب). وهذا لأن الله غاضبٌ والمشكلة تتركز عند الله، لهذا يجب أن نبحث عن ترضية له. والسؤال المطروح من يستطيع أن يقدم هذه الترضية؟
الإنسان نفسه لا يستطيع لأنه مغضوب عليه. وكذلك الملاك لأنه مخلوق. لهذا يجب أن تقدم من الله نفسه. وهكذا قُسّم الدور بين الآب والابن. الآبُ قَبِلَ الترضية والابن قدمها، وهذا يقسم الثالوث إلى إثنين، ويجعل دور الروح القدس كأنه لم يكن بالكليّة.
الموقف البروتستانتي:
يختلف البروتستانت مع الكاثوليك بأمور كثيرة ولكنهم متفقين معهم بهذه الفكرة، فهم يتحدثون عن الرحمة والعدل وأنه بالصليب قدّم المسيح الذبيحة التي فيها غفر الله للجنس البشري.
موقف الكالفينيين أو المصلحين:
من كتاب (علم اللاهوت القويم) (ذنب معصية آدم الأولى حُسبَ حالاً بقضاء الله على كل واحدٍ من نسلهِ منذ وجوده قبل أن يصدر منه عمل ما).
وباعتبار أن البروتستنت خرجوا من الكنيسة الكاثوليكية فقد ورثوا منها مفهومها الحقوقي. والمشكلة عندهم في تبرير الإنسان، وهذا التبرير في نظرهم هو الكفُّ عن اعتبار الإنسان مذنباً في نظر الله، وذلك بسبب الذبيحة التي قدّمها المسيح. وفي هذا تلتقي محبة الله مع عدله، وبذلك يكون لبُّ المشكلة أن نزيل غضب الله، هذا هو الموقف الغربي ككل.
بالمقابل عند الآباء الأرثوذكس المشكلة ليست عند الله بل أن المشكلة هي في صميم الإنسان، وهي مشكلة كيانية.
الموقف الأرثوذكسي من الفداء:
لا يمكن الفصل بين تجسد الله وعمله الخلاصي، لأن كل الخلاص هو شامل، بالنسبة للخلاص الذي صنعه المسيح يبدأ من لحظة التجسد عندما اتخذ المسيح طبيعتنا الساقطة جاعلاً إياها طبيعة خاصة له ولكن بدون خطيئة، ووحدها مع طبيعته الإلهية. وهنا يبتدأ بإنقاذ طبيعتنا من تفككها وفسادها ورفعها إلى الدرجة الأشد سمواً من الكمال بالنسبة لها، بدون أن تفقد خواصها الذاتية. أي أنه من لحظة التجسد كانت البداية لأنه من أي وجه أخذ سر الفداء أو سر الخلاص نجد أنه بهذا التجسد بداية تحقيق الخلاص المطلوب. الله والبشر بعيدين عن بعضهما فيأتي المخلص ليصبح في تجسده الوسيط بين الله والإنسان (1تيمو 2) لأنه وحدّ بين طبيعتيهما. التشديد هو على أن البداية في التجسد لأنه منه يتدرج الخلاص حتى يكتمل، ومنه ينتشر. وبالتالي لا يمكن النظر إلى الخلاص من زاوية معينة واحدة أي من لحظة الموت وانتهاء الغضب الإلهي.
لذلك إذا أخذنا أثناسيوس الكبير الذي يذكر أهمية التجسد في الخلاص فيقول “فكما أن نزول الإمبراطور إلى المدينة والإقامة في أحد البيوت، ليس فقط يهبّ هذه المدينة إكراماً عظيماً، بل يجعل أي لص لا يجرؤ على مهاجمتها. لأن حضور الإمبراطور هو حفظ لها، هكذا إمبراطور السماء من لحظة نزوله إلى منطقةِ إنسانيتنا وسكناه في جسد يخصنا، انتهت كل هجمات العدو ضد الإنسان والفساد بطلّ”.
كيرللّس الإسكندري يقول: “منذ أن اتخذ الكلمة جسداً انطفأ في الجسد سمّ الحية وقوة الشر أزيلت منه. وقضي على الموت الذي نتج عن الخطيئة… لقد أخذ الكلمة جسداً مخلوقاً ومادياً. وبما أنّ الخالق جدّده وآلههُ في ذاته ليقيمنا جميعاً إلى مثاله، إلى ملكوت السموات”.
من هذه التعابير كل هجمات العدو. أزيلت قوة البشر… نستطيع القول أنه بالقوة أي الإمكانية المستقبلية حقق السيد عمله الإلهي، فابن الله صار في منطقتنا الإنسانية، أي أن البداية حصلت وسوف يتم اكتمالها. لأن الكلمة الإلهية لا ترجع فارغة. والكلمة الإلهية صارت في الجسد البشري وقوتها ستظلُ فعّالة وبالتالي الشر سيبطل.
ما هو الموقف بالنسبة للكتاب المقدّس؟ وكيف نفهم سرّ الخلاص والفداء؟
إذا أردنا أن نكون موضوعيين، فإن الكاثوليك والبروتستانت عندما ركّزوا بموضوع الفداء على الغضب والذبيحة والتعويض. اعتمدوا على آيات من الكتاب المقدس تؤيد فكرة الذبيحة والمصالحة مع الله. لكن المشكلة هي في فهم المواضيع وليس في وجود الآيات…
بالنسبة لنا كلما حاول الإنسان أن يكتفي بجانب واحد من الموضوع، لا يستطيع أن يكتشف عمل الله، لأنه أعمق من أن تستنفذه زاوية واحدة. ولكن هذا السرّ يلفت نظرك ويذهلك. ولا زاوية من الزوايا يمكن أن تعطي فكرة واضحة عن الموضوع. فالموضوع ليس مشكلة رياضية. بل هو عمل إلهي إنساني فيه غرابة كبيرة فلا تستطيع إلاّ أن تأخذ ملامح عن الموضوع، وهو ما سنحاول أن نلفت النظر إلى بعض هذه الملامح:
1- الفداء ووظائف المسيح الثلاثة:
نلاحظ في كثير من كتب اللاهوت عند الطوائف الثلاثة عندما يتحدثون عن سرّ الفداء يبدءون بالقول أنه توجد ثلاثة وظائف للمسيح هي: “نبي، رئيس كهنة وملك” كالفن أعطى أهمية كبرى لهذه الوظائف بالنسبة لسرّ الفداء في كتبه. وأيّ كاتب أرثوذكسي يستطيع أن يلاحظ هذه الوظائف الثلاثة للمسيح، وعليها يبنى ماهية سرّ الفداء منطلقاً من وظيفة النبي، وكيف تصرّف المسيح في ذبيحته كرئيس كهنة، وكيف انتصر كملك وسوف ينتصر في النهاية، حتى عند بعض الآباء مثل يوحنا الذهبي الفم أو كرللّس الأورشليمي، وردت إشارات إلى هذه الوظائف بالنسبة إلينا ليس من الضرورة استعمال هذه الطريقة، وإن استعملها بعض الأرثوذكس فهو لتسهيل العرض.
2- الفداء كذبيحة:
“في العهد القديم أشعياء 4:53-11 جعل نفسه ذبيحة إثم”.
” مز 6:40-9 بذبيحة و تقدمة لم تسرّ أذني فتحت محرقة وذبيحة خطيئة لم تطلب حينئذٍ قلتُ هاأنذا جئت. يدرج الكتاب مكتوب عني”، هذا المزمور أنه عندما ترجم في السبعينية ترجم بدلاً بذبيحة وتقدمة لم تسرُّ أذنيّ فتحت…” هكذا “وذبيحة وتقدمة لم تشأ لكنك هيأت لي جسداً” هذا أذهل المفسرين. والمعنى أن الله في العهد القديم كان يتشكّى من المحرقات والذبائح لأنها كنت تقدّم بدوافع خطيئة. وليس من قلب نقي. الذي سيأتي هو الذي سيقدم الذبيحة المقبولة وإن الجسد الذي هيّأه له الآب سيكون هو الذبيحة، ويستعمل بولس هذا النص في (العبرانيين 5:10-7) كما جاء في السبعينية ليثبت أهمية ذبيحة المسيح بالنسبة لذبائح العهد القديم، إذاً الفكرة في العهد القديم موجودة بأن المسيح سيقدّم كذبيحة.
في العهد الجديد (عبرا 11:9-14) يتحدّث عن المسيح رئيس الكهنة الذي قدّم دمَ نفسه، فوجد فداءً أبديّاً. (عبرا 21:9-28) (وكل شئ تقريباً يتطهّر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة).
“أفسس 2:5” وأسلمَ نفسَه قرباناً وذبيحة لله.
لقد شدّد البروتستانت على الذبيحة التي بدونها لا يغفر الله كما كان في العهد القديم.
وبتقديم هذه الذبيحة ـ ذبيحة المسيح ـ تمت كل العمليّة وانتهى غضب الله، وتصالح مع الإنسان. ومن هنا نفهم لماذا عندهم فكرة الإيمان فقط، فقط أمن بذبيحة المسيح التي بدونها لم يكن الله ممكناً أن يغفر. لأنه بدم المسيح على الصليب تمّ الغفران وتمّ الخلاص، والإيمان بهذا يخلّص الإنسان.
والسؤال المطروح : هل يجب فهم هذه الآيات في هذا الإطار أم بآخر لم ينتبهوا إليه؟ إذاً هذه المقارنة مهمة مثلاً على ذلك: إذا أتى جندي في الحرب وقام بمخاطرة أدت إلى استشهاده من أجل إنقاذ رفاقه من الخطر، ألا يمكننا أن نقول أنه قدّم نفسه ذبيحة من أجلهم؟ فإذا اعتبرنا هذا التمثيل فلمن قدّم هذه الذبيحة؟
الجواب.. أنه قدّم الذبيحة لأجل اخوته… وهذا ما حصل بالنسبة للمسيح.
يقول القديس غريغوريوس اللاهوتي أن المسيح قدّم ذبيحة. ولكن لمن قدّمها؟.. إذا قدّمها للشيطان ـ حسب أوريجنس ـ الذي يحتجز البشر ويريد فدية.
فهذا تجديف فظيع أن يكون قدّمها للشيطان، أي أن تقدم للصٍ حقير. الإله فدية. وإذا قلت للآب. فهل يمكن أن يطلب الآب ذبيحة ابنه حتى يرضى؟ فالسرّ بذبيحة ابنه أنه هو نفسه أحبنا حتى بذل ابنه عنا “هكذا أحبّ الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به..” (يو16:3).
ونعرف أن محبة الله الآب للابن هي مطلقة ومتبادلة وهنا معنى الذبيحة الحقيقية التي قدمت أمام الله الآب، لأن كل شئ من الآب ويعود إليه، لأن الآب والإبن والروح القدس عندهم الإرادة الواحدة. إرادة المحبة. والذبيحة قدّمت لا لإرضاء الآب لأنه غاضبٌ، بل لأن الذبيحة تعني ضمناً الآم المسيح وموته التي من خلالها تمّ شفاء طبيعتنا البشرية وتحريرها وتقديسها وتخليصها وتأليهها. الذبيحة قدّمت من أجلنا نحن. الذبيحة مربوطة بنا وليس بالآب، ومفهوم البروتستانت والكاثوليك إذاً خاطئ لأنهم يربطون الذبيحة بإرضاء الله وليس خلاص البشر الذي بذل ابنه لكي يخلص كل من يؤمن به، إذاً الذبيحة قدّمت من أجلنا نحن وسفك الدم الوارد في عبرا 21:9 إشارة للعهد القديم حيث لم يكن هناك غفران بدون سفك دم، وإشارة أيضاً إلى الذبيحة التي قدمها المسيح إلى الله وكان بها سفك دم، وبها حصل الغفران والمصالحة والتجديد، ولو لم يسفك دم المسيح لم تحصل الذبيحة وبالتالي كنا بدون خلاص.
3- الفداء كطاعة:
في الأساس من ملامح الخطيئة أنها عدم طاعة لناموس الله. ولأننا لم نطع الوصية حصل بنا ما حصل، لذلك من جديد الطاعة لله هي الخطوة الأولى للمصالحة بيننا وبينه “رو 19:5” لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطأة، هكذا أيضاً بطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبراراً. هنا يوجد مقارنة بين آدم القديم الذي لم يطع فسقط وآدم الجديد الذي أطاع ليس فقط بإسمه كإبن لله لأبيه بل بإسم البشر كلهم وكإبن للبشر، لهذا يعتبر مجيئه على الأرض من أجل أن يطيع. والطاعة التي أطاع فيها المسيح أيضاً هي مثال لنا من أجل أن يتعلموا البشر أن يقدموا الخضوع اللائق لله ويمجدّوه (يو 4:17) (أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأكمل قد أكملته)، كل عمل هو من الآب يتمم بالابن يكمل بالروح القدس.
“مز 7:40” (هاأنذا جئت يدرج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي…)، أي مشيئة الآب والإبن والروح القدس، وأنّ الطاعة أساسية ومهمة كوجه من وجوه الفداء لأن المسيح بطاعته شفى الجنس البشري.. الذي يقدم طاعته لم يتمم مشيئة الله. القضيّة الأهم في “فيلبي 8:2” (وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب)، إن ابن الله كان في صورة الله وصار في صورة عبد. وليس المهم الطاعة بحد ذاتها، أي أن يصبح الإبن طائعاً. بل ما أدت إليه هذه الطاعة، أي أن هدف مجيء المسيح لم يكن ليرضي الله الذي كان غاضباً لأنه طلب وصية ولم تنفّذ. والكرامة الإلهية تفترض عدم مخالفتها. ولكن في الواقع أن هدف طاعته لإرادة الله كان لخلاص البشر، ومشيئة الآب والإبن والروح القدس هي خلاص الجنس البشري، لأجل هذا أطاع المسيح حتى الموت موت الصليب. وقد كان صعباً بالنسبة إليه كعبدٍ “كإبن البشر” أن يطيع المشيئة الإلهية بجملتها (إذاً كان يمكن أن تعبر عني هذه الكأس). ولكنه أطاع حتى الموت، ولم يكن فيه غش أو خطيئة، وهذا من أجلنا كلياً وليس من أجله ولا من أجل الآب صارت هذه الطاعة، إنه أطاع حتى الموت لأن إرادة الثالوث هي خلاصنا.
كيف تؤدي هذه الطاعة للخلاص؟ في “فيلبي 9:2-12” (لذلك رفعه الله أيضاً وأعطاه إسماً فوق كل إسم..) فهدف الطاعة والموت والصليب موجودة في كلمة رفعه. لقد أتى ونزل حتى العمق الأقصى من الألم والضغط والموت والضيق حتى يحصل على هذا الترفيع. وهذا الترفيع ليس من أجله بل من أجل جنس البشر الذي به حصل حقيقة خلاص الجنس البشري.
4 – الفداء كتغيير كياني لطبيعة الإنسان:
تتلخص الفكرة عند الآباء أن المسيح أخذ طبيعتنا حتى يصنع فيها هذا الخلاص العظيم الذي كنا بأمّس الحاجة إليه.
والمشكلة في طبيعتنا أنها متجهة نحو الموت ومعرضة للألم وميّالة نحو الشرور وخائفة من الموت، هذه الطبيعة لديها الأقمصة الجلدية التي هي الأهواء غير المعابة مثل: الحزن، الألم، الجوع، العطش، البرد، التعب، العرق…. ولكن هذه أعطيت للإنسان لتناسب وضعه بعد السقوط، ولكنها بحد ذاتها مزعجة. فإذا تألم شخص فهو يتألم لحدوث حادث مضر للجسم، ولكن الألم بحد ذاته بركة فهو إنذار بالخطر ووجوده له ضرورة قصوى، فهو شرّ لا بدّ منه، وأتى المسيح وأخذ كل شئ ما عدا الخطيئة. فهي الشيْ الوحيد الذي لم يشابهنا فيه، فهو حمل كل الأهواء غير المعابة، لقد تعب وحزن وتألم ومات كل هذه أخذها بتمامها ليقضي عليها جميعاً. فقد أخذ كل واحدة بكمالها حتى يقضي عليها بما هو ضدها، فقد أخذ الألم حتى الثمالة حتى أبطل الألم. وأخذ الموت حتى تمامه حتى لم يعد يوجد موت.
والسؤال المطروح… لماذا عندما أخذ هذه بتمامها أدى إلى تغيير الموضوع بتمامه كيانياً؟ البعض قال أنه بسبب إتحاد الطبيعتين. ولكن الطبيعة الإلهية لا تقوم بالتغيير إلاّ إذا قبلت الطبيعة البشريّة بالتخلي عن ذاتها (من يحب ذاته يهلكها).
العملية معكوسة بالكلية فكلنا متجهون لإرضاء ذاتنا وإشباع أهوائنا حتى ترتاح وكلما زاد إشباع أهوائنا زاد فسادها، وهكذا نظل في الموت، فالمسيح وحده استطاع أن يسلك الإتجاه المعاكس بإخلاء الذات بالكليّة (لأجل ذلك أخلى ذاته آخذاً صورة عبد)، فهذا أول إخلاء ذات حيث أن الطبيعة الإلهية أخذت الطبيعة البشرية المحدودة والمعرضة للضعفات.
(أخلى ذاته آخذاً صورة عبدٍ وأطاع حتى الموت) (وأطاع حتى الموت موت الصليب).
الطاعة هي استمرار لإخلاء الذات، ليس كإله فقط بل كإبن للبشر أيضاً، لهذا يمكننا القول أنه منذ وجود المسيح على الأرض هو في عملية إخلاء ذات ولم يرضي ذاته بشيء، فعندما جاع وفرك تلاميذه القمح لم يَقُم هو بهذا، وبهذا لم يخالف الناموس، فإذا كان يأكل فإنّ ذلك لكي يستمر في الحياة، وليس لإرضاء الذات. ولم يكن له بيت يسكن فيه ولا أيّ شيء من أجل رفاهيته وإرضاء ذاته. فعندما كان يتحداه الناس لم يقم بإعطاء آيات وعمل معجزات من أجل إرضاء ذاته، لهذا أخلى ذاته منذ البداية حتى وصل إلى الآلام الكبرى، فلم يتألم أيّ شخصٍ من الجنس البشري كما تألّم المسيح بسبب حساسيته وحمله لآلام الجنس البشري واختياره في ذاته نتائج الخطيئة المريعة التي وصلوا إليها… بخضوع الإرادة البشرية للإلهية يوجد إخلاء للذات، فدور إبن البشر مهم، ومكسيموس المعترف يقول: (بسبب كون إرادة يسوع غير منجذبة نحو اللذة والخطيئة لم يبحث أن يهرب من الألم بل صبر عليه حتى النهاية وذاقه حتى النهاية، وبقي صاحياً في حياته التي كانت كلها حياة ألم، يسوع تحمّل ألماً أعظم من كل البشر، لأنه اختبر في ذاته النتائج المريعة للخطيئة، للبؤس الذي سقطوا فيه لهذا حمل في ذاته نتائج خطيئتهم كل عذاب من أجل الخطيئة، لا بل عذاب خطايا الكل لأنه في آخر المطاف، في الألم الأقصى يتركز كل ما هو شر في الخطيئة، ولكن بالضبط وبسبب قبوله هذا الألم الهائل رافضاً نهائياً تجربة الشرير، غلب بطبيعته الخوف من الألم).
بكلمات أخرى، حتى ينقذ الناس من الألم تحمّل الألم حتى آخره، وعملية الألم هنا هي استمرار لإخلائه لذاته. وما إشارة مكسيموس أنّ ألم المسيح كان أكثر من ألم كل البشر إلاّ لأنه ذاق بنفسه من خلال بشريته، إلى أي مدى تعذّب البشر نتيجة للخطيئة. لذلك حمل خطايانا كما يقول أشعياء وهو الذي بلا خطيئة، ولأنه هو محبة تألم من أجلنا وحمل خطايانا.
هذا التضادّ الذي حدث نتغنى به في الكنيسة فنقول غلب الموت بالموت، ويمكن القول غلب الألم بالألم، بهذا رفع يسوع طبيعتنا البشرية إلى مرتبة عليا من الوجود إلى ملئ الحياة التي هي النتيجة الحتمية لقيامته بالجسد، بناءً عليه كل الذين يموتون في المسيح يسوع لا يذهبون إلى الموت الأزلي بل ينتقلون إلى الحياة. الموت زال في المسيح في كل الذين يتحدون معه.
5 – التمجيد والرفع في حياة الإنسان:
(التأله هو نفسه التمجيد والرفع).
يو 23:12-24 قد أتت الساعة، يعني فيها لحظة الموت والتي هي لحظة التمجيد، التخلي الكلي عن الذات لأجل المحبة، والذي يذكّرنا بعمل آدم المعاكس، الذي لم يكن فيه تخلٍ عن الذات. لأن نتيجة إخلاء يسوع لذاته كإنسان الوحدة الكلية للطبيعة الإلهية والبشرية فيه، فالمسيح هيّأ لذلك في التجسد. فصارت الوحدة حقيقية في التجسد، ولكن الآن تصل إلى ملئها “الوحدة” فالطبيعة الإلهية تفيض مواهبها الكلية على الطبيعة البشرية في لحظة الموت. لهذا حدثت القيامة التي هي التمجيد الكلي للطبيعة البشرية، لأنه حدث فيها الإفراغ الكلي للذات، وهذا هو معنى التمجيد الكلي الذي يتكلم عنه الكتاب المقدس.
6 – الفداء كتحطيم للجحيم:
هوشع 14:13 (من يدّ الهاوية أفديهم …)، هذا الكلام يستعمله بولس الرسول في (1كور 54:15-55) (أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هاوية)، وأيضاً في “عبرا 14:2” (قد تشارك الأولاد في اللحم والدم … لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس…) هذه الآية تشير إلى أن سرّ الفداء اكتمل بإبادة الموت وسلطان إبليس، وأنه حصل التجسد واكتمل بالموت الذي به أباد سلطان الموت وأعتق الذين تحت العبودية، فإذا ربطنا موضوع الجحيم في هوشع وكورنثوس والعبرانيين يكون السؤال: كيف أدّى الفداء إلى تحطيم الجحيم؟ وأدّى إلى إبادة سلطان الموت أي إبليس؟ وما هو معنى أن إبليس حامل سلطان الموت؟ هنا نلاحظ أنه لم يدفع أحد فدية لإبليس، بل جاء إلى بيت القوي من هو أقوى منه لكي يبيده، وتوجد عملية صراع وتحطيم، ولكن السؤال: كيف تحطم سلطان القوي إبليس؟ كيف حطم المسيح سلطان الجحيم؟ عملية تحطيم الجحيم عملية فعليّة وليست شعرية.
أولاً: حصل هذا التحطيم عبر جسد يسوع باتحاد الطبيعة الإلهية بالبشرية الكلي أي عندما وصلت الطبيعة البشرية إلى ملء التخلي عن الذات، فاجتاحتها القوى الإلهية بالكلية وأبادت الموت في عالم الطبيعة البشرية فحصلت القيامة. لذلك أيضاً المسيح هو الممسوح بالمعنى المطلق، لأن هذا الاجتياح قد حدث في المسيح الذي امتلأ نفساً وجسداً من المواهب الإلهية ولهذا الكنيسة هي جسد المسيح، لأن جسده صار المالك لكل المواهب الإلهية التي تعطى لنا بالأسرار.
ثانياً: حصل هذا التحطيم عبر نفس يسوع البشرية، أي عندما نزل إلى الجحيم بعد لحظة الموت على الصليب، فهو نزل إلى الجحيم، بنفسه المتحدة بالقوى الإلهية التي اجتاحت طبيعته البشرية، وهذه القوى الإلهية بالذات هي عينها الفردوس المفقود الذي فقده الإنسان ونتج عنه الموت الروحي، فالمسيح يعود الآن ويرجع هذه القوى الإلهية إلى النفس البشرية.
وحتى الأبرار في العهد القديم كانوا يفتقدون هذه القوى الإلهية لذلك كانوا في الجحيم بعد الموت، وكانوا تحت سلطان الشيطان. المسيح أرجع القوى الإلهية التي فقدها الإنسان بالسقوط. فخلّص الناس من قبضة إبليس لأنه كان له سلطاناً على البشر، وذلك لأن الناس بسبب طبيعتهم الفاسدة لم يكن لديهم القوى الإلهية التي تساعدهم على التخلص من قوى إبليس، فكانوا يجربون ويخطئون. كذلك عندما كانوا يموتون يكونون في الجحيم تحت سلطان إبليس نتيجة لفقدانهم إياها. والآن عندما تأتي القوى الإلهية (فأين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية) وأين سلطانك يا إبليس. الآن كل بارّ في الجحيم يصبح متحدّاً مع القوى الإلهية. هذا هو الفردوس بمفهومه الأرثوذكسي، وهذا هو معنى تحطيم الموت.
7 – الفداء كجمع الكل في المسيح يسوع وعلاقة ذلك بالأسرار:
هناك من يقسم فداء المسيح، فيجعله نظريات مختلفة متضاربة فمثلاً قال البعض: إن إيريناوس أيضاً كانت عنده نظريته الخاصة حول الموضوع معتمداً على “أفسس 10:1” (لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك). فغاية الفداء إذاً بحسب إيريناوس أن يجمع كل شيء في المسيح، ما في السموات (الملائكة) وما على الأرض (العالم) وكل شيء يجمع في المسيح،وهكذا صار المسيح آدم الثاني، وذلك لأنه جمع في نفسه كل الجنس البشري ليقدسه ويعيد اتحاده بالله. فقد تم إتحاد البشرية مع الله مبدئياً منذ تجسّد ابن الله، فيبدو هنا ولأول وهلة وكأن موضوع الفداء والموت والذبيحة ليس له أهمية كبرى بالنسبة لهذه النظرية، ولكن إيريناوس عندما شدّد على نتيجة عمل يسوع الفدائي لم يكن غافلاً عن بقية الجوانب لأنه التكملة الطبيعية لعمل المسيح، وقد أراد أن يربط الفداء ربطاً محكماً يوضع البشرية ككل، فالفداء متجه أساساً نحو البشرية الساقطة كلها. ولذلك كل ما صنعه المسيح كان من أجلنا أصلاً وحاصل فينا، وحتى قبل أن نتعرف عليه بالإيمان. وفي الواقع توجد وحدة روحية غير مدركة للبشرية جمعاء في المسيح يسوع، وهو ما نجده مزروعاً في الكتاب. كقول بولس الرسول في رسالته إلى أفسس (وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع) “أفسس 6:2″ أي أن المسيح احتوانا في طبيعته البشرية، فعندما قدّم طبيعته البشرية للموت، قدّمنا كلنا معه وإلهنا معه، وأقامنا معه، وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. أمثال هذه العبارات تتردد كثيراً في الصلوات الكنسية وعند الآباء، فيمكن القول كما أن آدم القديم احتوى البشرية كلها وأسقطها معه، وهذا واقع بسبب توريثه الطبيعة الفاسدة التي أعطاها، فالآن آدم الجديد يحتوي البشرية الجديدة ويحولها من جديد، (1 كو 15: 45-50 ): صار آدم الإنسان الأول نفسا حية وآدم الأخير روحا محييا … أي انه كما أن آدم القديم ألبسنا التراب، أي إن خاتمة حياتنا أن نعود إلى التراب ، الإنسان الأول من الأرض ترابي، والإنسان الثاني الرب من السماء، الآن يورثنا المسيح باتحاده معنا السماء، وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس صورة السماوي وهذا حدث بصورة خاصة في لحظة الموت أو لحظة التمجيد. وكمثال عن احتوائنا في المسيح، من الصلوات الكنسية، نأخذ طروبارية سحر عيد البشارة:” اليوم ينكشف السر الذي قبل الدهور، إن ابن الله يصير ابن البشر، لكي يهبنا الأفضل باتخاذه الأدنى. لقد خاب آدم القديم ولم يصر إلها كما اشتهى، فصار الإله إنسانا، لكي يصير آدم إلها.” فهنا يوجد آدم القديم وآدم الجديد. فعمل آدم الجديد انه اصبح مركز الإنسانية والواهب لها الحياة، أي انه الشعلة التي تعطي لانهائية الحياة الأبدية، وهو هنا يعطي من الغنى الذي عنده، فيوزع المواهب الإلهية، وينبع كل انهار النعمة.
والسؤال … كيف اصبح المسيح المركز وموزع المواهب؟ أي ما هي صلة الوصل بين طبيعة المسيح وطبيعتنا؟
كانت الصلة مع آدم القديم بصورة خاصة عبر الوراثة، بينما مع آدم الجديد هناك كما قلنا وحدة سرية بيننا وبينه، لأنه صار شريكا لنا في اللحم والدم بالتجسد، ونبعا للقوى الإلهية بالقيامة. وبهذا صار مركزا للطبيعة البشرية ككل ومصدرا للقوى الإلهية فيها. معنى هذا إن طبيعتنا البشرية اصبح الآن في وسطها قوى إلهية هائلة. من هنا نستطيع أن نفهم أيضا موضوع الأسرار، التي هي هذه القوى الإلهية بعينها وتعطى نتيجة للوحدة مع المسيح، ففي المعمودية نلبس المسيح، نموت معه ونقوم معه. فهناك وحدة بيننا وبين المسيح وبين الأعضاء الآخرين. وفي الميرون ننمو في الوحدة والحياة الروحية معه. وفي المناولة نتحد كليا مع المسيح. فالأسرار هي بصورة خاصة لكي تربطنا مع المسيح، ونصبح بها جسد المسيح، وهذا هو المعنى الحقيقي للكنيسة، لكننا إذا صرنا واحدا مع المسيح، هذا معناه في نفس الوقت أننا نقتات الحياة الإلهية التي فيه، لأجل ذلك فالمركز المهم بالنسبة للإنسانية هي طبيعة المسيح البشرية المتحدة مع الإلهية والمؤلهة بالتجسد والموت والقيامة. لأنها سر حياة المسيحي أساس المعنى العميق لمفهوم الكنيسة، فالكنيسة ليست هي المؤمنين فقط بالمسيح، بل هي نتيجة مباشرة لعمل المسيح الفدائي ومتصلة دائما وبدون توقف معه. (أفسس 1: 18-23)